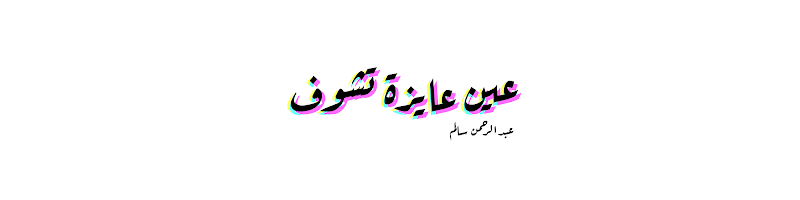بُهِرت.
هذا ما حدث عندما
استمعت إلى أغنية "والنبي يا ماّ". يُسجّل محمود الليثي هنا أسطورته عن النساء، بدون
تعقيد. لا وجود للتفلسف الشعبي الذي يشتهر به الشعراء المغمورين. لا وجود للفراخ أو اللحمة ولا للسجاير البُني ولا للجمل الدينية التي تجذب انتباه المستمع. فقط تعبير صارخ/واضح يضع
قانونًا ثابتًا لشخصية بسيطة جدًا لا تفتعل التعقيد ولا تحاول كبح جماح نفسها في
التعبير عن رأيها بكل جراءة. محمود الليثي يُعبّر هنا عن رأيه في بنات اليوم. لم يصفهن بالجمال ولم يصفهن بالقبح. لم يضع عبارات غزل في كلماته كما يفعل ثلاثة أرباع
جيله، ولم يؤكد على أنهم بمجانين ولا بأن فيهم ربع ضارب. فقط يوضّح بحيادية تامة
رأيه، وإن كان عنيفًا. وليحدث ما يحدث.
وفي نفس
السياق وبشكل موازي، يكتب صفات البنت التي يبحث عنها. لا داعي بقه لإظهار إن إنتا
بيهمك العيون، والأخلاق الكريمة وهذا الهراء. لأ. بكل وضوح يؤكّد
محمود أن فتاة أحلامه كفتاة أحلام أي مصري آخر. عايزها (حِلوة، طِعمة،
مبتقولش بابي ومامي، بيضا، متطلبش منه يودّيها مشاوير). بس. مش عايز أكتر من كده.
في عصرنا هذا،
من النادر أن تجد أغنية بهذه العفوية والانطلاق، ملعونة أبو الكلمات وأبو مواطن
الجمال وأبو الأحاسيس. عبّر عن نفسك ولو بالصراخ لسِت الحاجّة، إحكيلها، فهي
دائمًا ما ستنصت إليك. مش شرط تُرُد عليك على فكرة. قولها "والنبي ياما. هموت
عليها ياما"، لن ترد عليك. ولكنها ستكتفي بإخبارك إن الجامعة فيها بنات
حلوين.
وهو ما فعله
محمود الليثي. ذهب للجامعة بالفعل ليُفاجيء أن كل البنات والولاد هناك فرافير. لم
يتقبل الأمر. لم يسكت. صرخ مؤنبًا والدته أن "دول مش هينفعونا يامّا. هيجننونا
يامّا. هيطهقونا يامَا". ومنعًا للشك، وإستمرارًا في رحلة البحث "الشريفة" عن
فتاة أحلامه، يؤكّد في النهاية أنّه بالرغم من جرأته وجنونه لن يدخل البيت إلا من
بابه... ليُنهي الأغنية وهو يشير إلى فتاة أحلامه، محدثًا والدته: "هيّا ديّا
يا مّا. هموت عليها يا مّا. نروح لأبوها يا مّا."
بلغة تصل إلى المواطن البسيط يحجز محمود الليثي تذكرة
لنفسه في قطار ملوك الغناء الشعبي، ليؤكِّد أن أيدلوجية الغناء الرومانسي
أو الحالم بشكل عام لا تصلح دائمًا مع المواطن الذي لا يعي الرومانسية لأنه – كدة ولّا
كده - لم يُجربها بعد. فالبحث ما زال جاريًا.
أغنية تضع حدودًا
بين الواقع والخيال، ليس للتفريق بينهما، بل لإظهار التباين الأخّاذ الذي لن يظهر إلّا
إن كان هناك إبداع خالص في التعبير عن الفكرة، أيًا كانت جرأتها أو تفاهتها
بالنسبة للبعض.